كعلماني، وديمقراطي، عمل ولا يزال من أجل دولة المواطنة المتساوية، التي لا تميّز بين مواطناتها ومواطنيها على أي أساس، وأنتمي إلى حزب يرفع شعار المواطنة المتساوية كأحد أهدافه الخمسة التي يناضل من أجلها (العلمانية، الديمقراطية، المواطنة، التنمية، السلام)، أجدني محرجاً في الحديث عن نموذج الحكم والهويات في المجتمع السوري، الذي كشف عن انقسامات، بعضها حاد وعميق، في حقل الهويات.
ما يخفف من حرجي الأخلاقي والسياسي، بل يدعم ذهابي نحو تحليل هذه الإشكالية، هو ما أسماه المفكر السوري الراحل ياسين الحافظ “الحاجة إلى وعي مطابق”، واستناداً إلى هذه الحاجة الملحة، سأتخلى عن الطهرانية الزائفة لأخوض في الواقع الذي وصلنا إليه، من دون إغفال إشكاليات تشكّل الوطن السوري، وموازين القوى الدولية التي أفضت إلى ظهوره، إسوة بدول المنطقة.
منذ أن تشكّل الوطن السوري، مع نهاية الخلافة العثمانية، وقدوم الانتداب الفرنسي، كانت آلة السياسة في سوريا، في معظمها، أي في تياراتها الرئيسية الكبرى، كانت تعمل بدلالة رفض الحدود الدولية لسوريا سايكس-بيكو، ويكفي التذكير هنا أن الإسلاميين والقوميين والشيوعيين لم يعترفوا بهذه الحدود أيديولوجياً وعملياً.
وإذا كانت الجمهورية الثانية (1962-2011) هي الأكثر استقراراً، فإن استقرارها كان آلة لاحتكار الهويات ما فوق الوطنية، باسم العروبة، وفي الوقت نفسه، كبح جماح الهويات ما دون الوطنية (العرقية، الدينية، الطائفية، المناطقية، العشائرية)، من دون أي عمل جدي نحو بناء دولة المواطنة، ما جعل كل تلك الهويات في حالة كمون، وقد كان يسيراً بعد 2011 أن تُعاود تلك الهويات الظهور بأشكال حادة، بعضها ظاهر وفاقع، وبعضها أقل بروزاً، لكنه ليس أقل أثراً.
إن خطاب الكراهية السوري، في جزءٍ كبيرٍ منه، هو انعكاس لهواجس الهوية، والخوف من الآخر، وبعيداً عن التغذية الإقليمية والدولية لهذا الخطاب، فإنه، ومن دون إنكار، هو جزء من صيرورة فشل غياب المواطنة، لكن خطاب المواطنة في حالة الانقسام السوري، ومع اعتراف الكثير من القوى به، لا يلبي وحده مطالب بعض الفئات الاجتماعية التي تمتلك هواجساً تتعلق بالهوية.
ما من جهة في سوريا اليوم قادرة أن تقدم ضمانات للأطراف الأخرى، وقد دفع هذا الأمر، ولا يزال يدفع، نحو التفكير في نظام الحكم الذي يمكن أن يحقق مسألتين في الوقت ذاته: المسألة الأولى مطالب فئات عرقية، ودينية، محددة، والمسألة الثانية: المواطنة المتساوية.
السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة هو: كيف يمكن تحقيق صيغة حكم تراعي في دستورها ومؤسساتها وقيمها حقوق فئات معينة، وفي الوقت ذاته لا تعيق تحقق المواطنة المتساوية.
بداية، يجب القول إن نظام الحكم الأنسب في هذه الحالة هو نظام الحكم البرلماني، الذي يكون فيه موقع الرئيس شرفياً، مع القليل من الامتيازات السياسية، وألا يجري انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، لأن هذا يعطي عملية الانتخاب شرعية ديمقراطية-سياسية وازنة، قد تسمح للرئيس لاحقاً بإحداث انقلاب نحو نظام شبه رئاسي، ولاحقاً رئاسي، وبالتالي أن يجري انتخابه من خلال البرلمان، عبر التوافق أولاً، وفي حال تعذر التوافق يتم اللجوء إلى التصويت، مع ضرورة توفر ثلثي الأعضاء لنجاح المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وبما أننا نتحدث عن نظام برلماني، فقد يكون اللجوء إلى وجود برلمان ومجلس شيوخ عاملاً مساعداً، لكن مع وجود قواعد أكثر صرامة في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يكون عددهم الإجمالي ربع أعضاء البرلمان، وفي العادة فإن فقهاء الدستور يحبذون أن يكون عدد أعضاء البرلمان هو الجذر التكعيبي لعدد السكان، وفي بلد مثل سوريا (حوالي 25 مليون) يكون الجذر التكعيبي بحدود 140، وبالتالي فإن عدد أعضاء مجلس الشيوخ سيكون حوالي 40 عضواً، يمثلون جميع المحافظات السورية بالتساوي (نسب متساوية للمحافظات، بعيداً عن التفاوت في عدد السكان).
ليس هنا مجال الخوض في دور مجلس الشيوخ، وطريقة انتخاب أعضائه، لكن وجوده، من وجهة نظرنا يمكن أن يساعد إلى حدّ كبير في إعطاء نوع من التمثيل المتوازن للفئات الاجتماعية المحلية، من دون أن يكون لهذا المجلس أي سلطة في قوانين المواطنة المتساوية، والتي ينبغي أن تكون مثبتة في الدستور، من دون أن يكون هناك أي حق للحكومات المتعاقبة في تغييرها، وهي القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية والسياسية للمواطنين (الحقوق المدنية).
في هذا الوضع، فإن اللامركزية، على الرغم من بعض مشكلاتها، فإنها النظام الأنسب، خصوصاً لمنع العودة إلى الاستبداد، ومساعدة المجتمعات المحلية في عمليات التنمية، مع الأخذ بالحسبان أن الوزارات السيادية لا تخضع للامركزية، مثل الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، مع وجود آليات للتشبيك بين الإدارات المحلية والمركزية، خصوصاً في معالجة الأزمات الوطنية (أوبئة، كوارث طبيعية، وغيرها).
أما السلطة التنفيذية، وهي المؤسسة التنفيذية الحاكمة، فهي المكان الأكثر إشكالية، خصوصاً في الحالة السورية، لأن الوضع السوري لم يبلور، ما عدا الحالة الكردية، زعامات واضحة، يمكن القول إنها تمثل فئات دينية أو فئوية، وهو أمر جيد من وجهة نظرنا، لأنه سيبقي عملية التمثيل خاضعة للتوافق، وليس لعملية محاصصة، وهو ما يحمي، إلى حد ما، القضايا المرتبطة بالمواطنة المتساوية.
إن كتابة هذا المقال، في هذه اللحظة من عمر الصراع السوري، هي نتيجة لتوقعنا أننا نقترب، وفق بعض المعطيات الدولية، من نقاش القضايا المتعلقة بنظام الحكم، وهي قضايا إشكالية، خصوصاً في ظل الانقسامات المجتمعية الكبيرة التي برزت خلال السنوات السابقة.
(www.hds-p.org)











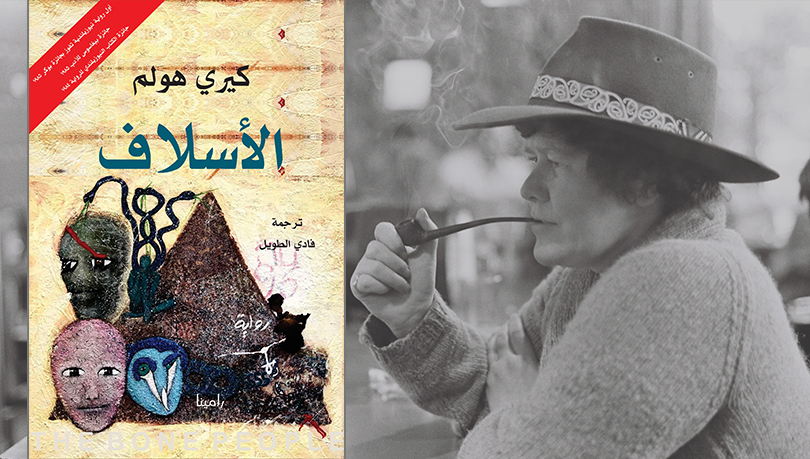





0 تعليقات